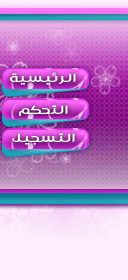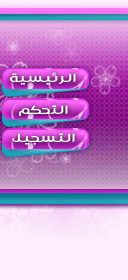الانتفاضة التونسية والحالة المصرية: نقاط لقاء وافتراق
الاربعاء, 26 يناير 2011

صلاح سالم *


طالما
كان كارل ماركس تواقاً إلى هبوب الثورة الشيوعية للإطاحة بالرأسمالية،
وتحقيق حلمه الاشتراكي، الذي ارتآه دوماً محطة أخيرة ونموذجاً خلاصياً
للتاريخ. وقد تحقق حلمه بالفعل وهبت الثورة الشيوعية، ولكنها انطلقت من غير
المكان الذي تخيله، فبينما كان الموطن الأثير لثورته هو ذلك الغرب المفعم
بالرأسمالية، خصوصاً في بريطانيا العظمى، جاءت الثورة البلشفية من قلب
الشرق الأوروبي، من روسيا التي لم تستحكم فيها الرأسمالية بعد، بل كانت حتى
ذلك الحين لا تزال أقرب إلى النظام الإقطاعي، وكان تلك مفارقة كبرى يمكن
نسبتها إلى “دهاء التاريخ”.
ولأسباب كثيرة يمكن الادعاء بأن الانتفاضة الشعبية في تونس على هذا
النحو الذي تمت به، والآثار التي رتبتها، كانت مفاجأة حتى لأكثر المتفائلين
أو ربما المتشائمين، فالكثيرون ربما انتظروا تلك الانتفاضة من المشرق
العربي، وبالذات من مصر لأسباب كثيرة، ليس أهمها الرد على وقائع الانتخابات
الاشتراعية الأخيرة، غير أنها جاءتهم من المغرب. ولا يقلل من حجم المفاجأة
أو المفارقة حال الاضطراب التي امتدت في الشارع التونسي لأكثر من شهر
قبلها، ذلك أن تونس، على رغم تفشي احتجاجاتها المطلبية، تتمتع بمستوى معيشي
مميز قياساً إلى الدول العربية غير النفطية التي تناظرها كمصر. كما أنها
تخلو من الانقسامات الطائفية أو القبلية أو المذهبية التي قد تشكل أقبية
للاحتقان الداخلي، أو حتى للاحتراب الأهلي، فكل ما تعرفه تونس من انقسامات
لا يعدو الغيرة السياسية الجهوية بين أقاليمها المختلفة، يحفزها الرغبة في
اغتنام مواقع سياسية أفضل. وفضلاً عن ذلك، فإن نظامها السياسي على استبداده
كان فعالاً غير معطل، على الأقل ظاهرياً، ناهيك عن طبيعة ارتباطاته
الخارجية بمراكز القرار الغربي والتي يفترض أنها توفر له ذلك القدر الأقصى
من الشرعية الخارجية.
يمكن الادعاء كذلك بأن أكبر الأزمات التي تعانيها تونس تشاركها فيها مصر
خصوصاً على صعيدين: أولهما الاستبداد الذي يكاد يؤدي إلى موت السياسة، حيث
اختطفت الحكومة الدولة، واختطفت الدولة التاريخ، وتغوَّلت على أهل الوطن،
ورثة هذا التاريخ.
وبمرور الوقت انطفأت الزعامات الكبرى، بفعل تأميم السياسة، وتوقف الحوار
الجاد حول الحاضر والمستقبل بفعل القمع، فصارت مصر أشبه بجسد ضخم من دون
رأس. لقد ماتت السياسة في مصر لأن الدولة قوية جداً، بهيـــــئاتها
التنـــــفيذية وأجهزتها الأمنية وبيروقراطيتها العتيقة إلى الدرجة التي
أبطلت السياسة كفعل خلاق، وأبقت عليها بل أذكتها كفعل إداري روتيني يومي
يقوم على تنفيذ اللوائح وتمرير الأوامر من أعلى إلى أدنى حتى صارت القرارات
الكبرى المصيرية التي تخص وطناً كبيراً يحوي ثمانين مليوناً من البشر تصدر
في غمضة عين، أو ظلمة ليل كالح، بعد فاصل من تصفيق حاد من نواب حزب حاكم
تصوت أغلبيته بشكل ميكانيكي، بلا حوار داخلي حقيقي، ولا تعاطف منها أو بعض
فئاتها مع طروحات الأقلية ولو لمرة واحدة في أي قضية مهما كانت جماهيرية،
فلم يُرد قانون واحد أرادته الحكومة مهما كان طاغياً، أو مفتقداً للخيال،
على منوال ما كان من تمديد لقانون الطوارئ، أو تمرير لقانون الضرائب
العقارية، على رغم أن القانون، أي قانون، لا يعدو كونه نوعاً من عملية
تنظيم للحياة في كل مجال، ولا بد أن يحظى بالتراضي العام، الذي يفرض على من
يصدروه أن يراعوا مصالح جميع الأطراف المعنية به، وهو ما لم يتوافر لأي من
هذه القوانين.
وثانيهما تفشي الفساد وصيرورته بنية متكاملة عائلية ونخبوية في تونس،
ونخبوية في مصر، إلى درجــة تـــــبدو قاتلة، أدخلت المجتمع في أزمة عميقة
جوهرها ســــوء التوزيع المفرط، بل والاحتكار الشديد في بعض الأحيان أو
المجالات، الأمر الذي قضى على أية نجاحات ممكنة قد تترتب على تزايد الكفاءة
الإنتاجية في بعض القطاعات. المشكلة الأكبر هي أن وطأة الشعور المجتمعي
بالفساد قد أتت على سيادة القانون، وأعجزت الدولة عن ممارسة دورها في ضبط
العلاقة مع الناس، وبينهم بما يضمن للجميع حق الحياة المطمئنة، ذلك أن
السلطة التي تستطيع تحقيق الانضباط وممارسة الحساب هي نفسها المسؤولة عن
تقديم البدائل الاجتماعية، والفرص الاقتصادية.
وفي مقابل عجزها عن تقديم هذه البدائل الموضوعية، تعجز تلقائياً عن
ممارسة الحساب والضبط اللازمين، إلى درجة صارت معها ترى انفلات المجتمع
فيما تصمت عما ترى وما يدور، لوذاً بالصمت اللذيذ كشريك في حالة النفاق
العام التي لا بد أن تسود في كل نظام مغلق، وثقافة سياسية جدباء.
بل يمكن القول بأن مصر، فضلاً عن ذلك الأمرين، ربما حازت ظواهر ثلاث
سلبية يفترض أن تدفع بسيناريو الغضب إلى ما هو أبعد قياساً إلى تونس:
الظاهرة الأولى: تتعلق باتساع نطاق حرية التعبير الصحافي والإعلامي،
الأمر الذي كان يفترض إما أن يكون رأس رمح للانفتاح السياسي ومقدمة له،
وإما أن يهيئ الأجواء لمثل تلك الانتفاضة. غير أن ما حدث لم يكن هو ذلك
الأمر، أو نقيضه، بل كان هو الحفاظ على الأمر الواقع أو تأميمه، إذ تحول
الفضاء الإعلامي من منتدى للحرية إلى حائط مبكى يسكب الناس عنده جل
انفعالاتهم في المساء، قبل أن ينصرفوا إلى نومهم أكثر هدوءاً، ليصبحوا في
اليوم التالي على وقائع دورة جديدة للانفعال والتفريغ النفسي بمصاحبة ذلك
الفضاء الموازي.
الظاهرة الثانية: هي الفتنة الطائفية التي صارت تتفجر بشكل متواتر،
وبإيقاع متزايد منذ بداية الثمانينات بخاصة في المناطق العشوائية في
القاهرة الكبرى، حيث يشيع الفقر، وينسد أفق الحياة، ويغيب الأمل، أو في
جنوب الصعيد حيث يشيع الجهل، وتتحكم التقاليد البالية. بل أنها، وفي
الأعوام الخمسة الماضية، وصلت إلى مدينة كالإسكندرية، وكان ذلك أمر مدهشاً
وغريباً، فالمدينة التي عرفت التسامح طيلة تاريخها اللهم سوى حوادث نادرة
واستثنائية يصعب أن تستسلم للتعصب إلا في أكثر اللحظات ركوداً وتدهوراً،
وهي الحال الذي في ما يبدو أننا صرنا إليه.
الظاهرة الثالثة: تتمثل في الاحتجاجات العلنية والإضرابات المتوالية
لفئات كثيرة ضد الدولة على مدى السنوات الخمس الماضية، والتي بدت تعبيراً
عن أشواق ديموقراطية عميقة ومحرومة لدى مجتمع صبر على التسلط طويلاً في ظل
دولة الرعاية الاجتماعية، ولكنه لم يعد قادراً على تحمل هذا القدر من
التسلط المتنامي، مع ذلك القدر المتعاظم من الفساد والانحياز الطبقي، ولذا
فإنه يحاول استعادة وعيه بالسياسة كاملاً كفكرة وحضور وممارسة تحتاج إلى
تعميق وترشيد من خلال المؤسسات الدستورية القائمة ولكن من دون بطء قد يدفع
الشارع بإيقاعه السريع إلى الغليان ومحاولة فرض مطالب فوضوية لن تكون في
مصلحة الوطن الذي يظلّل الجميع.
* كاتب مصري