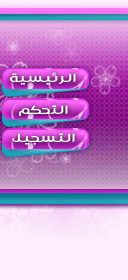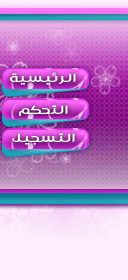مصدر الموضوع الاصلي: تفسير سورة البقره من { 167-176 }
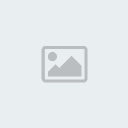
{ 165 - 167 } ثم قال تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ * إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ }
ما أحسن اتصال هذه الآية بما قبلها، فإنه تعالى, لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة, وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين, المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن { مِنَ النَّاسِ } مع هذا البيان التام من يتخذ من المخلوقين أندادا لله أي: نظراء ومثلاء, يساويهم في الله بالعبادة والمحبة, والتعظيم والطاعة.
ومن كان بهذه الحالة - بعد إقامة الحجة, وبيان التوحيد - علم أنه معاند لله, مشاق له, أو معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته, فليس له أدنى عذر في ذلك, بل قد حقت عليه كلمة العذاب.
وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله, لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير, وإنما يسوونهم به في العبادة, فيعبدونهم، ليقربوهم إليه، وفي قوله: { اتخذوا } دليل على أنه ليس لله ند وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له, تسمية مجردة, ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى: { وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ }
{ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ } فالمخلوق ليس ندا لله لأن الله هو الخالق, وغيره مخلوق, والرب الرازق ومن عداه مرزوق, والله هو الغني وأنتم الفقراء، وهو الكامل من كل الوجوه, والعبيد ناقصون من جميع الوجوه، والله هو النافع الضار, والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء، فعلم علما يقينا, بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا، سواء كان ملكا أو نبيا, أو صالحا, صنما, أو غير ذلك، وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة, والذل التام، فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: { وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ } أي: من أهل الأنداد لأندادهم, لأنهم أخلصوا محبتهم له, وهؤلاء أشركوا بها، ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة, الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه، والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئا, ومحبته عين شقاء العبد وفساده, وتشتت أمره.
فلهذا توعدهم الله بقوله: { وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا } باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله, وسعيهم فيما يضرهم.
{ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ } أي: يوم القيامة عيانا بأبصارهم، { أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ } أي: لعلموا علما جازما, أن القوة والقدرة لله كلها, وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء، فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها, لا كما اشتبه عليهم في الدنيا, وظنوا أن لها من الأمر شيئا, وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه، فخاب ظنهم, وبطل سعيهم, وحق عليهم شدة العذاب, ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا, ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها, من حيث ظنوا نفعها.
وتبرأ المتبوعون من التابعين, وتقطعت بينهم الوصل, التي كانت في الدنيا, لأنها كانت لغير الله, وعلى غير أمر الله, ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له, فاضمحلت أعمالهم, وتلاشت أحوالهم، وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين, وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها, انقلبت عليهم حسرة وندامة, وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا، فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل، فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجو, وتعلقوا بغير متعلق, فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها، ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها, فضرتهم غاية الضرر، وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين, وأخلص العمل لوجهه, ورجا نفعه، فهذا قد وضع الحق في موضعه, فكانت أعماله حقا, لتعلقها بالحق, ففاز بنتيجة عمله, ووجد جزاءه عند ربه, غير منقطع كما قال تعالى: { الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ }
وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم, بأن يتركوا الشرك بالله, ويقبلوا على إخلاص العمل لله، وهيهات, فات الأمر, وليس الوقت وقت إمهال وإنظار، ومع هذا, فهم كذبة, فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنما هو قول يقولونه, وأماني يتمنونها, حنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرأوا منهم والذنب ذنبهم، فرأس المتبوعين على الشر, إبليس, ومع هذا يقول لأتباعه لما قضي الأمر { إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ }
{ 168 - 170 } { يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ *
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ }
هذا خطاب للناس كلهم, مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض، من حبوب, وثمار, وفواكه, وحيوانات, حالة كونها { حَلَالًا } أي: محللا لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة, ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم، أو معينا على محرم.
{ طَيِّبًا } أي: ليس بخبيث, كالميتة والدم, ولحم الخنزير, والخبائث كلها، ففي هذه الآية, دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة، أكلا وانتفاعا, وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته, وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له, وهو المحرم لتعلق حق الله, أو حق عباده به, وهو ضد الحلال.
وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب, يأثم تاركه لظاهر الأمر، ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به - إذ هو عين صلاحهم - نهاهم عن اتباع { خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ } أي: طرقه التي يأمر بها, وهي جميع المعاصي من كفر, وفسوق, وظلم، ويدخل في ذلك تحريم السوائب, والحام, ونحو ذلك، ويدخل فيه أيضا تناول المأكولات المحرمة، { إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ } أي: ظاهر العداوة, فلا يريد بأمركم إلا غشكم, وأن تكونوا من أصحاب السعير، فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته, حتى أخبرنا - وهو أصدق القائلين - بعداوته الداعية للحذر منه, ثم لم يكتف بذلك, حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به, وأنه أقبح الأشياء, وأعظمها مفسدة فقال: { إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ }
أي: الشر الذي يسوء صاحبه, فيدخل في ذلك, جميع المعاصي، فيكون قوله: { وَالْفَحْشَاءِ } من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الفحشاء من المعاصي, ما تناهى قبحه, كالزنا, وشرب الخمر, والقتل, والقذف, والبخل ونحو ذلك, مما يستفحشه من له عقل، { وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } فيدخل في ذلك, القول على الله بلا علم, في شرعه, وقدره، فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه, أو وصفه به رسوله, أو نفى عنه ما أثبته لنفسه, أو أثبت له ما نفاه عن نفسه, فقد قال على الله بلا علم، ومن زعم أن لله ندا, وأوثانا, تقرب من عبدها من الله, فقد قال على الله بلا علم، ومن قال: إن الله أحل كذا, أو حرم كذا, أو أمر بكذا, أو نهى عن كذا, بغير بصيرة, فقد قال على الله بلا علم، ومن قال: الله خلق هذا الصنف من المخلوقات, للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك, فقد قال على الله بلا علم، ومن أعظم القول على الله بلا علم, أن يتأول المتأول كلامه, أو كلام رسوله, على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال, ثم يقول: إن الله أرادها، فالقول على الله بلا علم, من أكبر المحرمات, وأشملها, وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها, فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده, ويبذلون مكرهم وخداعهم, على إغواء الخلق بما يقدرون عليه.
وأما الله تعالى, فإنه يأمر بالعدل والإحسان, وإيتاء ذي القربى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلينظر العبد نفسه, مع أي الداعيين هو, ومن أي الحزبين؟ أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية, الذي كل الفلاح بطاعته, وكل الفوز في خدمته, وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة, الذي لا يأمر إلا بالخير, ولا ينهى إلا عن الشر، أم تتبع داعي الشيطان, الذي هو عدو الإنسان, الذي يريد لك الشر, ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الذي كل الشر في طاعته, وكل الخسران في ولايته، الذي لا يأمر إلا بشر, ولا ينهى إلا عن خير.
ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله - مما تقدم وصفه - رغبوا عن ذلك وقالوا: { بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا } فاكتفوا بتقليد الآباء, وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس, وأشدهم ضلالا وهذه شبهة لرد الحق واهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق, ورغبتهم عنه, وعدم إنصافهم، فلو هدوا لرشدهم, وحسن قصدهم, لكان الحق هو القصد، ومن جعل الحق قصده, ووازن بينه وبين غيره, تبين له الحق قطعا, واتبعه إن كان منصفا.
ثم قال [تعالى]: { وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ }
لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل, وردهم لذلك بالتقليد, علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق, ولا مستجيبين له, بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم، أخبر تعالى, أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها, وليس لها علم بما يقول راعيها ومناديها، فهم يسمعون مجرد الصوت, الذي تقوم به عليهم الحجة, ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم, فلهذا كانوا صما, لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول, عميا, لا ينظرون نظر اعتبار, بكما, فلا ينطقون بما فيه خير لهم.
والسبب الموجب لذلك كله, أنه ليس لهم عقل صحيح, بل هم أسفه السفهاء, وأجهل الجهلاء.
فهل يستريب العاقل, أن من دعي إلى الرشاد, وذيد عن الفساد, ونهي عن اقتحام العذاب, وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه, وفوزه, ونعيمه فعصى الناصح, وتولى عن أمر ربه, واقتحم النار على بصيرة, واتبع الباطل, ونبذ الحق - أن هذا ليس له مسكة من عقل, وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء, فإنه من أسفه السفهاء.
{ 172 - 173 } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }
هذا أمر للمؤمنين خاصة, بعد الأمر العام, وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي, بسبب إيمانهم, فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق, والشكر لله على إنعامه, باستعمالها بطاعته, والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا }
فالشكر في هذه الآية, هو العمل الصالح، وهنا لم يقل " حلالا " لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له.
وقوله { إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } أي: فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله, لم يعبده وحده, كما أن من شكره, فقد عبده, وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب, سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر, عقيب النعم؛ لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة, ويجلب النعم المفقودة كما أن الكفر, ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة.
ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ } وهي: ما مات بغير تذكية شرعية, لأن الميتة خبيثة مضرة, لرداءتها في نفسها, ولأن الأغلب, أن تكون عن مرض, فيكون زيادة ضرر واستثنى الشارع من هذا العموم, ميتة الجراد, وسمك البحر, فإنه حلال طيب.
{ وَالدَّمَ } أي: المسفوح كما قيد في الآية الأخرى.
{ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } أي: ذبح لغير الله, كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار, والقبور ونحوها, وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات، جيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: { طَيِّبَاتِ } فعموم المحرمات, تستفاد من الآية السابقة, من قوله: { حَلَالًا طَيِّبًا } كما تقدم.
وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها, لطفا بنا, وتنزيها عن المضر، ومع هذا { فَمَنِ اضْطُرَّ } أي: ألجئ إلى المحرم, بجوع وعدم, أو إكراه، { غَيْرَ بَاغٍ } أي: غير طالب للمحرم, مع قدرته على الحلال, أو مع عدم جوعه، { وَلَا عَادٍ } أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له, اضطرارا، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال، وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها، { فَلَا إِثْمَ } [أي: جناح] عليه، وإذا ارتفع الجناح الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بهذه الحالة, مأمور بالأكل, بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة, وأن يقتل نفسه.
فيجب, إذًا عليه الأكل, ويأثم إن ترك الأكل حتى مات, فيكون قاتلا لنفسه.
وهذه الإباحة والتوسعة, من رحمته تعالى بعباده, فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: { إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }
ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين, وكان الإنسان في هذه الحالة, ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها - أخبر تعالى أنه غفور, فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال, خصوصا وقد غلبته الضرورة, وأذهبت حواسه المشقة.
وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: " الضرورات تبيح المحظورات " فكل محظور, اضطر إليه الإنسان, فقد أباحه له, الملك الرحمن. [فله الحمد والشكر, أولا وآخرا, وظاهرا وباطنا].
{ 174 - 176 } { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ }
هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله, من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله, أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي, ونبذ أمر الله, فأولئك: { مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ } لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه, إنما حصل لهم بأقبح المكاسب, وأعظم المحرمات, فكان جزاؤهم من جنس عملهم، { وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار، { وَلَا يُزَكِّيهِمْ } أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة, وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله, والاهتداء به, والدعوة إليه، فهؤلاء نبذوا كتاب الله, وأعرضوا عنه, واختاروا الضلالة على الهدى, والعذاب على المغفرة، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار, فكيف يصبرون عليها, وأنى لهم الجلد عليها؟"
{ ذَلِكَ } المذكور, وهو مجازاته بالعدل, ومنعه أسباب الهداية, ممن أباها واختار سواها.
{ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ } ومن الحق, مجازاة المحسن بإحسانه, والمسيء بإساءته.
وأيضا ففي قوله: { نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ } ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه, وتبيين الحق من الباطل, والهدى من الضلال، فمن صرفه عن مقصوده, فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة.
{ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ } أي: وإن الذين اختلفوا في الكتاب, فآمنوا ببعضه, وكفروا ببعضه، والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم { لَفِي شِقَاقٍ } أي: محادة، { بَعِيدٍ } عن الحق لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، فمرج أمرهم, وكثر شقاقهم, وترتب على ذلك افتراقهم، بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به, وحكموه في كل شيء, فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه.
وقد تضمنت هذه الآيات, الوعيد للكاتمين لما أنزل الله, المؤثرين عليه, عرض الدنيا بالعذاب والسخط, وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق, ولا بالمغفرة، وذكر السبب في ذلك بإيثارهم الضلالة على الهدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة، ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار, لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة إليها، وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه, وعدم الافتراق، وأن كل من خالفه, فهو في غاية البعد عن الحق, والمنازعة والمخاصمة, والله أعلم.

تفسير سورة البقرة كااملا